تطور مفهوم العلم في الفكر الإسلامي
يسعى هذا البحث إلى رصد التحولات والتطورات التي لحقت بمفهوم كلمة "علم" في الفكر الإسلامي بدأ من ما ورد في الكتاب والسنة وأقوال كبار الصحابة وكذلك أراء فلاسفة الإسلام المبكرين والمتكلمين بحسب التدرج التاريخي والتعرض للتحولات التي لحقت بالمفهوم في فكر عصر النهضة إلى وقتنا الحاضر مع الإشارة إلى أثر مفهوم العلم عند الغربيين وأثر ذلك في الفكر العربي والإسلامي الحديث. كما سيتطرق إلى إشكالية التحولات التي تمر بها المعاني الأساسية التي تضاف إلى هذا المفهوم. بحيث قد تتعارض الدلالات بين عام وخاص ومطلق ومقيد، بل وقد تتعدد المعاني وتتناقض من فترة لأخرى. ونرى – كما سيتضح – أن التطور التاريخي للمصطلحات لا يأخذ بالضرورة منحى تقدميا، أو أن المصطلح مع تقدم الزمن يصبح أكثر وضوحا أو اصطلاحية وإنما على العكس من ذلك تماما، نجد أن المفهوم قد يأخذ معاني ودلالات متعددة ومع الوقت يصبح بالأحرى أكثر غموضا بسبب تنوع وتعدد الاستخدامات الدلالية له.
ولعل الاختلاف بالمقياس إلى مفردة مثل "العلم" كثيرة الاستخدامات ومن ثم متعددة الدلالات، لن يقف عند الدلالة والمعنى وإنما سيطال الوظيفة والقيمة المرتبطة بالمفهوم من حيث هو معيار أو قيمة من ناحية ووصف لأسلوب تفكير من ناحية أخرى. وقد يخصص المفهوم لتحديد نوعية أو موضوع المجال الذي يشير إلى ذلك. والإشارة إلى تعدد مجال "العلم" في الفكر الإسلامي بارز من البداية، فبعض معاني كلمة "علم تظهر" كما تم توظيفها في القران الكريم، لم يعد يحملها المفهوم في سياق استخدامات كثيرة لكلمة "العلم" اليوم، رغم أن المعنى التقليدي الفضفاض المفهوم لا يزال متداولا في أوساط معينة، بمعنى أن المفهوم من بدايته يحمل في جوانبه شيئا من تعددية المعنى بل وربما غموضه، وهو ما نأمل أن يسمح المسح التاريخي الذي يسلط أضواء جديدة عليه.
تأتي مفردة "علم" في القرآن على أشكال عدة، فهي تارة نكرة، وهو التنكير الذي يأتي في سياق الإشارة على أن "العلم" المذكور هو مجرد معرفة قد تكون نافعة أو قد تكون ضارة، كما هو في قوله تعالى: (وأضله الله على علم)(1) إلا أن المفردة غالبا ما تتكرر في صيغة التعريف " العلم "، للدلالة على الأرجح على علم بذاته، أو للإشارة إلى شيئا باسم العلم، أو تشريفا لهذا المفهوم في دلالات معينة خاصة، كما هو الحال في قوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم)(2) وقوله: (ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد)(3) وقوله: (وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به قتخبت له قلوبهم وأن الله لهاد الدين آمنوا إلى صراط مستقيم)(4) ولقد حددت هذه الآيات مفهوم العلم بأنه العلم الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الله وأنه علم يهدي إلى صراط العزيز الحميد . ولهذا فإن القرآن في هذا السياق يؤكد على أهمية من حصلوا على هذا العلم ومنزلتهم، وهو ما يؤكد عليه قوله تعالى: (ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق). حتى إن النص القرآني يقرر في آية أخرى" إنما يخشى الله من عباده العلماء)(5) ويحسم في آية أخرى: (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)(6) والانحراف عن "العلم" بهذه الصيغة يؤدي إلى الجهل والضلال والفرقة، (وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم)(7)، وقوله: (وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم)(8) ورغم أن النص القرآني إنما حدد مفردة العلم بالوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا التعريف العام يتطلب تفسيرات وشروح مؤكدة على المعنى العام للمفهوم وارتباطه بالهداية والرشد.
عندما حدث سعد بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى له في سفره، قال له مصوراً جهل القوم المرسل إليهم: أتيتك من قوم هم وأنعامهم سواء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا سعد ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ قوم علموا ما جهل هؤلاء ثم جهلوا كجهلهم"(8) وفي أحاديث أخرى عنه أنه قال: "العلم نور وضياء يقذفه الله في قلوب أوليائه"(9) وقوله: "العلم مجبول في قلوبكم تأدبوا بآداب الروحانيين يظهر لكم"(10) وعنه "أكثر الناس قيمة أكثرهم علما وأقل الناس قيمة أقلهم علما" (11) وقوله: "خير الدنيا والآخرة مع العلم، وشر الدنيا والآخرة مع الجهل"(12) وقوله: "الناس يعلمون في الدنيا على قدر منازلهم في الجنة"(13)
وهناك قول يستند إلى جملة هذه المعاني: "تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقه وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام وسالك بطالبه سبيل الجنة وهو أنيس في الوحشة وصاحب في الوحدة ودليل على السراء والضراء وسلاح على الأعداد وزين الأخلاء" (14) وكذلك قول: "يرفع الله به أقواما يجعلهم في الخير أئمة يقتدى بهم، ترمق أعمالهم وتقتبس آثارهم وترغب الملائكة في خلتهم، يمسحونهم في صلاتهم بأجنحتهم ويستغفر لهم كل شيء حتى حيتان البحور وهوامها وسباع البر وأنعامها، لأن العلم حياة القلوب ونور الأبصار من العمى وقوة الأبدان من الضعف ينزل الله حامله منازل الأخيار ويمنحه مجالس الأبرار في الدنيا والآخرة"(15) بالعلم يطاع الله ويعبد وبالعلم يعرف الله ويؤخذ بالعلم لتوصل الأرحام وبه يعرف الحلال والحرام والعلم أمام العمل والعمل تابعه يلهمه الله السعداء ويحرمه الأشقياء"(16)
وفيما ورد عن الإمام علي، رضي الله عنه، قوله: "الإيمان والعلم أخوان توأمان ورفيقان لا يفترقان" وقوله: "كلما ازداد علم الرجل زادت عنايته بنفسه ويذل في رياضتها وصلاحها جهده" وقوله: "يا مؤمن إن هذا العلم والأدب ثمن نفسك فاجتهد في تعلمها، فما يزيد من عملك وأدبك يزيد في ثمنك وقدرك فإن بالعلم تهتدي إلى ربك" وقوله: "يتفاضل الناس بالعلوم والعقول لا بالأموال والأصول"، وقوله "لا يعرف الرجل إلا بعلمه، كما لا يعرف الغريب من الشجر إلا عند حضور الثمر، فتدل الأثمار على أصولها" وقوله: "لا تستعظمن أحدا حتى تستكشف معرفته"، وقوله: "العلم رأس الخير كله"، وقوله: "العلم أصل كل خير والجهل أصل كل شر".
ويقسم علي العلم إلى أنواع: "العلم علمان، مطبوع ومسموع، ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع" ويوضح أن: "العلم مصباح العقل والعلم حجاب من الآفات" ويؤكد: "ليس العلم في السماء فينزل إليكم، ولا في تخوم الأرض فيخرج لكم، ولكن العلم مجبول في قلوبكم، تأدبوا بآداب الروحانيين يظهر لكم" ويقسم أنواع علم الإنسان "علم الناس كله في أربع أولها: أن تعرف ربك والثاني أن تعرف ما صنع بك والثالث أن تعرف ما أراد منك والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك" ومن حكمه: "أفضلكم أفضلكم معرفة"، و "قيمة كل امرئٍ ما يعلمه أو ما يحسنه"(17) ومن الواضح أن مفهوم العلم في النص القرآني والحديث النبوي وأقوال الإمام على ما يشير إلى مفهوم واسع محيطه، لكنه يدور حول فكرة المعرفة التي تهذب الإنسان وتقربه من الله وتنير عقله وقلبه، بمعنى أننا ربما نقابل في هذا السياق مفهوم المعرفة في مقابل اللوغوس بمعناه الكلاسيكي، المعرفة الروحية "اللدنية"، لكنها في ذات الوقت معرفة تقوم الذات وتهذب الأخلاق، لكن أيضا وفي نفس الوقت معرفة معرفة وإن كانت في شكلها العام المطلق "العلم" إلا إنها يمكن تحصيلها استقراء واستدلالا من خلال التجربة البشرية، وهي تعد شكل من أشكال "العبادة". لهذا فهي وإن كانت تقود إلى الحق والنجاة من الظلال في عالم الآخرة، لكنها وفي الوقت نفسه تضمن حياة أخلاقية وعملية في الحياة الدنيا.
هذه الدلالات والمعاني الأساسية ستشكل توجيهات وستفتح أبوابا ومسارات لمفهوم العلم في الحضارة الإسلامية – كما سنرى في مسيرة تطور المفهوم التاريخي حتى العصر الحديث – وربما بتأثيرات خارجية فلسفية وأخلاقية، ربما تبعد المفهوم على تأسيسه القرآني. ولعله من المفيد أن نؤكد مبدئيا أن "العلم" لم تختزل في النشاط العقلي والتأكيد على القدرة البشرية في التفكير العقلاني المحض، وفي الوقت نفسه لم يحدد "العلم" فقط بمصدرية إلهية وإنما كانت الإشارة إلى فعالية العلم في توجيهها لسلوك الإنسان وإيمانه في سياق المصلحة البشرية العليا التي تجددها القيم الدينية ذات المصدر الإلهي(18).
يتــــبع
يتــــبع
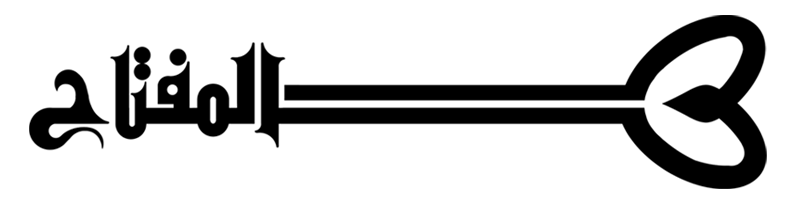
تعليق