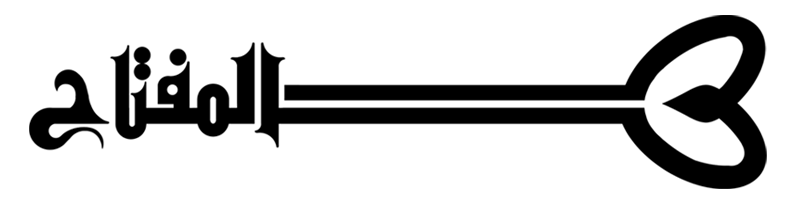عمر حمدي.. اللوحة عالم من اللانهاية
حوار: ســــلوى عبـــاس

المرسم المكان الوحيد الذي أمارس فيه طفولتي
اللوحة مرآة اللحظة والساعات الطويلة من التأمل والأسئلة
المرأة سر الرسم في حياتي.. هي سيدة الخلق والسلام
على الرغم من سنوات الاغتراب الطويلة بقيت الطفولة ذاكرة مفتوحة على الحلم في روح الفنان عمر حمدي، ومن يتمعن في لوحاته يقرأ عشقه لحالة الخوف واللحظات اللاإنسانية التي عاشها في مسيرة حياته، ووجدت إنعكاساتها في لوحاته بكل تفاصيلها لأن هذه الحالات هي التي جعلته يدرك معنى أن يكون رساماً، وأن يكون إنساناً، وعلى الرغم من المعاناة التي عاشها نراه يحتفي بالحياة، حيث اللون الذي يمثل العنصر الأهم في لوحته هكذا يقول: "كل شيء هو لون، يولد مع فتحة العين، وينتهي في المكان الذي ولدت فيه، اللون هو السر الأبدي للحياة"، ولذلك صنّفه النقاد كواحد من أهم الملونين في هذا العصر، حيث شكل الاغتراب المحرض لاكتشاف العالم، فالعلم كبير والفن يحمل غناه من حجم تجربة الفرد وقدرته على الاكتشاف والاختلاف. يعتبر عمر حمدي أن العمل الفني بطبيعته يعكس جانباً من التراث الإنساني، وهو جزء من الثقافة التأملية في حياتنا، وأهمية العمل الفني لم تكن يوماً باغترابه عن القراءة الجماهيرية، مهما اختلفت اتجاهاته وتقنياته، لأن اللوحة في النهاية تبدأ من إنسان لتستمر في إنسان آخر، ففي الفن كل شيء يصبح جميلاً، وهذا الجمال هو جزء من تجربته سواء كان مباشراً أم غير مباشر.
في معرضه الذي أقامه مؤخراً في صالة "آرت هاوس" تنوعت مواضيع اللوحات بين الانطباعية والتعبيرية التي تعكس فلسفة حمدي في الفن والحياة، وكان الهاجس الإنساني الذي شغله على مدى تاريخه الفني حاضراً في معرضه هذا، الذي مثّل اختصاراً للاتجاهات الفنية التي نقرؤها في مسيرته الفنية، وعلى هامش المعرض التقيته في محاولة للاقتراب من عوالمه الإنسانية والحياتية، فحدثني بداية عن طفولته ونشأته: " نشأت في شمال سورية، طفلاً مع الغنم وحقول القمح والقطن، مع الحصادين والرعاة والألوان المتشبعة بالغبار والشمس، تعلمت الكتابة من والدي على لوح أسود صغير معلق على حائط طيني، ومن هذا اللوح بدأت معي الإشارات الأولى بأن أكون رساماً في مكان لم أعرف من خلاله أن هناك مايسمى "بالفن" خارج ذلك الأفق الكبير.. والدي كان قاسياً عليّ وكان يرى "أن الرسم لايطعم خبزاً"، وهذا الرفض المتواصل جعلني أكثر ارتباطاً بالرسم، الذي كان المكان الوحيد لأمارس فيه طفولتي، ثم عملت بائع بوظة وكعك في الطرقات، إضافة إلى ساعات المدرسة التي دخلتها وأنا في الثامنة، ثم دخلت الإعدادية وبعدها درست في دار المعلمين إضافة لعملي في إحدى صالات السينما رساماً للملصقات وكناساً فيها آخر الليل.. ومن عملي هذا كنت أعطي والدتي كل يوم ثمن الخبز واللبن وبالباقي أشتري ألواناً وقماشاً، كنت أرسم والدتي وأخوتي وفلاحي القرية، وما يحيط بي، تعلمت الرسم بدون أستاذ أو معهد للفن، سوى ساعات الرسم التي كانت فراغاً في المدرسة، أو محاولة من جملة أساتذة يتغيرون من مكان لآخر، فالحسكة مكان لايعرف ما هو الفن، لذلك انطلاقتي الأولى بدأت من دمشق، حيث أقمت أول معرض في المركز الثقافي العربي، وبعد انتهاء المعرض أحرقت كل اللوحات، فقد كانت هناك نظرة غريبة وحساسية مرهفة تجاهي لأنني قادم من الشمال، فكنت أعمل بصمت وبعيداً عن الفنانين، كما حاولت أن أشارك بخجل في عدد من المعارض، لكن مشاركتي كانت دائماً في زاوية مهملة، أمام الأسماء التي كانت تسيطر على الحركة التشكيلية في سورية آنذاك، ثم التحقت بالخدمة الإلزامية التي طالت مدتها إلى سبع سنوات، وهناك لم يتوفر لي المكان أو المادة لكي أرسم بتواصل سوى الرسوم القلمية التي كنت أنشرها في المجلة العسكرية التي كنت أعمل فيها.. فسافرت إلى بيروت ومن هناك إلى قبرص ثم فيينا، حيث بدأت رحلة الاغتراب، وقبل سفري قدمت آخر لوحة لي هدية إلى المتحف الوطني، صالة الفن الحديث، وفي فيينا تعرفت على عالم مختلف تماماً، عالم حافل بصالات العرض والفنانين والمتاحف، لكن فيينا لم تكن أيضاً حميمة مع شاب يحمل اسماً عربياً وينام تحت جسورها أو في محطات قطاراتها وينتظر العشاء أمام إحدى دورها الخيرية للحصول على قطعة خبز محمصة أو شوربة ساخنة.
هكذا أمضيت السنوات الأولى وحيداً، أحمل لوحاتي من حين إلى آخر إلى صالات عرضها بلا اهتمام فعملت لصالح دكان لبيع اللوحات، وبدأت أخرج إلى الطبيعة، أرسم المشهد الانطباعي وتعلمت كيف يكون اللون وحركة الهواء، مع هذه الفصول الأربعة كانت بدايتي مع الخبز والشهرة وكان "مالفا" بديلاً عن"عمر حمدي" لضرورات التسويق، في عالم لم يتعلم بعد أن الإنسان واحد في كل مكان له تراثه وثقافته وخصوصيته.. ثم حصلت على الجنسية النمساوية وأصبحت عضواً في الاتحاد العام للفنانين النمساويين، ثم عضواً في لجنة التحكيم في تخرج الدبلوم لطلبة كلية الفنون.. وبدأت أعرض، ثم بدأت أعمالي تدخل أوروبا، بدءاً من ألمانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهكذا..
بعد رحلة الطبيعة كان عمر حمدي حاضراً كفنان، ذلك المغترب بحزنه وشوقه وخوفه وبراءته بعيداً قريباً من المكان، من الذاكرة السورية ورائحة التراب وحب الوالدة العجوز وهي تضع يديها على وجع قدميها، جالسة أمام الباب منتظرة وليدها الأول، لكن السنوات بزخمها وعذاباتها كانت طويلة الى أن تم اللقاء. ومن وقتها أعود من حين إلى آخر إلى الوطن، أعانق أهلي وأبحث عن أصدقائي القدامى أمتلئ بالانتماء ثم أسافر.
> ومرسمك ماذا يعني لك؟ وكيف هي علاقتك به؟ وكيف تنظر لبياض اللوحة؟
<<المرسم .. هو المكان الذي كنت أحلم فيه لسنوات طويلة، وهو اليوم على سفح جبل فيينا، بين غابة من الشجر، كبير يدخله الضوء بغزارة من جدرانه الزجاجية حين يكون الطقس شمساً، أدخله مثل ناسك، أسمع الموسيقى، أمتلئ بالشوق إلى اللوحة الفارغة، أتناول ألواني وفراشيّ وتبدأ المغامرة، مغامرة الكشف عن هذا المخزون النائم والمتراكم في الذات، عن التجربة الطويلة مع الحوار بين اليد والعين، عن ذلك السر اللانهائي بين الفنان ولحظة الإبداع، عن ملامح القلق الدائم مع اللون الطربي.. عالم من التداخلات المعقدة، لا تقبل الترجمة، أمنحها كل شيء لتعطيني كل شيء، مثل الجسد، مثل الطبيعة، مثل الوطن.
اللوحة مرآة اللحظة والساعات الطويلة من التأمل والأسئلة.. من أنا؟.. لماذا أرسم؟.. مع كل هذه المسؤولية تجاه الحياة والتطور الهائل للفنون الجديدة مع تقنيات ورؤى مستقبلية، تجعلني في النهاية أدافع عن نفسي على مساحة بلا حدود، عن اللوحة المحددة بأربع نهايات، عن موقعي وتأثيري ومكاني في هذا الزخم الهائل من الفنون، في يومنا هذا.. تعلمت بأن أكون منذ طفولتي وفي الغربة وبعد رحيل أطفالي الثلاثة إلى أمريكا وانقطاع أخبارهم عني لأكثر من خمسة وعشرين عاماً... لأنني وقتها لم أكن أكثر من رسام فقير، فقد حلمه بالعودة إلى الوطن الذي حمله معه، هذا الوطن الذي ظل يكبر في الذاكرة والعين، في لوحاتي وحياتي وثقافتي وعلاقاتي الإنسانية مع العالم الآخر.
في مرسمي أتأمل لوحاتي لأدخل لوحة جديدة، أي لعالم جديد من اللانهاية، ويأتي الليل، متعباً مثلي، أنام في مكاني، أستقبل الضوء وتبدأ الرحلة ثانية، أسافر، أدخل المدن الكبيرة، مازلت أهرب من الزحام، أدخل التفاصيل وأعيش متعة الروح في اللون والشكل، متعة الحياة بقدسيتها وجمالها، وأتعلم من جديد كيف أكون إنساناً.
وكيف بقيت محافظاً على ثقافة الشرق في أعمالك ضمن الثقافة الغربية؟
لم تكن مصادفة حين اختار التاريخ مكانه في سورية، ولم تكن مصادفة حين كتبت الأبجدية على قطع الطين المشوية ولم تكن الحضارة آنذاك تعرف بأن بقايا الحجر والتماثيل هي أحدث لغة في الفن المعاصر.. من هذه التربة ورائحتها خرجت إلى الغرب إلى العالم الكبير بحربيه العالميتين وتطوره التقني والمادي، بفنونه وحضاراته الإنسانية، مغترباً يحتمي بظل شجرة كبيرة يملأ عينيه من كل شيء، إضافات كبيرة تتراكم في الداخل تغنيني، أتأمل كل حدث جديد وأعود للجذور وتحولات التاريخ واستمرارية التراث والغرائز والحروب كشاهد على العصر، أصنع قدري بنفسي، أرسم لغتي، رؤيتي، أدافع عنها في كل مكان أعرض فيه، وأعرف أنني جدير بالمشاركة في الحوار من أجل سلام عادل على هذه الأرض ومن أجل كتابة تاريخ لم يكتب بعد، رسالتي هي الحب، هي عالم بلا حدود، عالم قابل للحياة، عالم يحترم الطبيعة، بأنها الأم المقدسة، عالم تملأ ساحاته بالألوان بدلاً من الدم، عالم نتحمل مسؤوليته من أجل البقاء والحرية والعدالة....
وهل يخضع عمر حمدي لمتطلبات السوق في فنه؟ أم أن إحساسه وما يشاهده هو المعيار لفنه؟
لم أرسم يوماً من أجل شيء سوى اللوحة، لأن اللوحة وحدها هي الخبز والبقاء والانتماء والتواصل، أعرف أننا في زمن يباع فيه كل شيء، وأعرف أن لوحتي تعلّق على جدار ما وليس في مرسمي، لكنني أرسم من أجل هذا الجدار سواء أكان في متحف أم في صالة عرض أم في ملتقى للفن أم في غرفة خاصة لإنسان ما..
في بدايات غربتي، حيث لا مال، لا أحد، لا اسم، كنت أرسم من أجل الخبز ومن أجل اللون، لكنني كنت سعيداً أنني قادر على الوقوف أنتظر العودة إلى عمر حمدي وإلى الحرية التي أستمدها من أعمالي بأنني واحد من فناني هذا العالم، جدير بالإضافة والتجديد.. ولأن المادة هي المحرك الأساسي في تاريخ الشعوب، والفن بحاجة إلى المتوفر المادي، فمن الرائع أن تُحدد أسعار أعمالي من صالات العرض وتُقتنى بهذه الغزارة، إنها سعادة الفنان حين تكون اللوحة جزءاً من سعادة الملتقى أو القادر على شرائها.. هكذا هي اللوحة لها قصتها أو سيرتها عبر التاريخ... وهي الحاضرة دائماً في الذاكرة الإنسانية كشاهد عصر وليس كشاهد نقدي.. اللوحة ليست رقماً أو ملكاً لأحد، إنها ملك نفسها فقط...
ترسم الوجوه بكل حالاتها الإنسانية، هل من علاقة تربطك بها؟
"الشاهد" أو الوجه الذي أرسمه، هو محاولة واقعية التفاصيل لأناس من دون إشارات أو دلالات محلية، هم "الإنسان" في وجهه، عذابه وحزنه، وتاريخه، تستوقفني هذه الوجوه التي تمر في حياتي وأحاول الدخول في تفاصيلها لأقول بصمت "أحبكم" هذه المجموعة هي جزء من أجساد جذوع الشجر أو من حقول اللون المتداخلة، لعوالم تجريدية حافلة بسيرة حياة ذاتية، ومعرفة محترفة مع الفن... لا يزال الوجه الإنساني بجغرافيته وحواره بديلاً عن وجهي، بديلاً عن لحظة حدوث الموت... أو القلق الدائم بين الحياة والموت.
والفن هل هو فعل تغيير؟ أم هو فعل مواز للحياة؟
الفن هو التاريخ، وهو الحضارة التي نعيشها اليوم ونرسم ملامحها للمستقبل، وبهذا فهو يغيّر ويدخل الحياة من حديقته الخاصة، لتكون الحياة أكثر جمالاً وتوازناً وتحملاً... هذا الفن بكل اتجاهاته من سينما ومسرح ولوحة ونحت وتقنيات ومواد معيشية وموسيقى وشعر، هو مجمل حياتنا بدءاً مما نرتديه إلى ما نودع فيه.. إنه الحافظ للتاريخ والديانات والقيم... ولد مع الإنسان وينتهي مع الطبيعة، فهو قدرنا وحياتنا واستمراريتنا... ما أرسمه في حدود اللوحة، هو المكان الذي لا يزال يرافقني، مكان أتعلم منه كيف أرسم وردة بيضاء بالدم...
والمرأة أين هي في أعمالك؟:
المرأة هي الحياة.. هي لوحتي، الجسد واللغة والاحتواء والوجه والذاكرة.. موجودة في جلد اللون وسطح المساحات، في التفاصيل، في روح المرئيات البصرية، علينا أن نرى ونتأمل طويلاً لنصل إلى التفاصيل وسر المكونات والمؤثرات غير المترجمة. إنها ربما سر الرسم في حياتي، هي مثل الطبيعة بفصولها، فهي سيدة الخلق والسلام وجديرة بالانتماء والتضحية.
اللوحة مرآة اللحظة والساعات الطويلة من التأمل والأسئلة
المرأة سر الرسم في حياتي.. هي سيدة الخلق والسلام
على الرغم من سنوات الاغتراب الطويلة بقيت الطفولة ذاكرة مفتوحة على الحلم في روح الفنان عمر حمدي، ومن يتمعن في لوحاته يقرأ عشقه لحالة الخوف واللحظات اللاإنسانية التي عاشها في مسيرة حياته، ووجدت إنعكاساتها في لوحاته بكل تفاصيلها لأن هذه الحالات هي التي جعلته يدرك معنى أن يكون رساماً، وأن يكون إنساناً، وعلى الرغم من المعاناة التي عاشها نراه يحتفي بالحياة، حيث اللون الذي يمثل العنصر الأهم في لوحته هكذا يقول: "كل شيء هو لون، يولد مع فتحة العين، وينتهي في المكان الذي ولدت فيه، اللون هو السر الأبدي للحياة"، ولذلك صنّفه النقاد كواحد من أهم الملونين في هذا العصر، حيث شكل الاغتراب المحرض لاكتشاف العالم، فالعلم كبير والفن يحمل غناه من حجم تجربة الفرد وقدرته على الاكتشاف والاختلاف. يعتبر عمر حمدي أن العمل الفني بطبيعته يعكس جانباً من التراث الإنساني، وهو جزء من الثقافة التأملية في حياتنا، وأهمية العمل الفني لم تكن يوماً باغترابه عن القراءة الجماهيرية، مهما اختلفت اتجاهاته وتقنياته، لأن اللوحة في النهاية تبدأ من إنسان لتستمر في إنسان آخر، ففي الفن كل شيء يصبح جميلاً، وهذا الجمال هو جزء من تجربته سواء كان مباشراً أم غير مباشر.
في معرضه الذي أقامه مؤخراً في صالة "آرت هاوس" تنوعت مواضيع اللوحات بين الانطباعية والتعبيرية التي تعكس فلسفة حمدي في الفن والحياة، وكان الهاجس الإنساني الذي شغله على مدى تاريخه الفني حاضراً في معرضه هذا، الذي مثّل اختصاراً للاتجاهات الفنية التي نقرؤها في مسيرته الفنية، وعلى هامش المعرض التقيته في محاولة للاقتراب من عوالمه الإنسانية والحياتية، فحدثني بداية عن طفولته ونشأته: " نشأت في شمال سورية، طفلاً مع الغنم وحقول القمح والقطن، مع الحصادين والرعاة والألوان المتشبعة بالغبار والشمس، تعلمت الكتابة من والدي على لوح أسود صغير معلق على حائط طيني، ومن هذا اللوح بدأت معي الإشارات الأولى بأن أكون رساماً في مكان لم أعرف من خلاله أن هناك مايسمى "بالفن" خارج ذلك الأفق الكبير.. والدي كان قاسياً عليّ وكان يرى "أن الرسم لايطعم خبزاً"، وهذا الرفض المتواصل جعلني أكثر ارتباطاً بالرسم، الذي كان المكان الوحيد لأمارس فيه طفولتي، ثم عملت بائع بوظة وكعك في الطرقات، إضافة إلى ساعات المدرسة التي دخلتها وأنا في الثامنة، ثم دخلت الإعدادية وبعدها درست في دار المعلمين إضافة لعملي في إحدى صالات السينما رساماً للملصقات وكناساً فيها آخر الليل.. ومن عملي هذا كنت أعطي والدتي كل يوم ثمن الخبز واللبن وبالباقي أشتري ألواناً وقماشاً، كنت أرسم والدتي وأخوتي وفلاحي القرية، وما يحيط بي، تعلمت الرسم بدون أستاذ أو معهد للفن، سوى ساعات الرسم التي كانت فراغاً في المدرسة، أو محاولة من جملة أساتذة يتغيرون من مكان لآخر، فالحسكة مكان لايعرف ما هو الفن، لذلك انطلاقتي الأولى بدأت من دمشق، حيث أقمت أول معرض في المركز الثقافي العربي، وبعد انتهاء المعرض أحرقت كل اللوحات، فقد كانت هناك نظرة غريبة وحساسية مرهفة تجاهي لأنني قادم من الشمال، فكنت أعمل بصمت وبعيداً عن الفنانين، كما حاولت أن أشارك بخجل في عدد من المعارض، لكن مشاركتي كانت دائماً في زاوية مهملة، أمام الأسماء التي كانت تسيطر على الحركة التشكيلية في سورية آنذاك، ثم التحقت بالخدمة الإلزامية التي طالت مدتها إلى سبع سنوات، وهناك لم يتوفر لي المكان أو المادة لكي أرسم بتواصل سوى الرسوم القلمية التي كنت أنشرها في المجلة العسكرية التي كنت أعمل فيها.. فسافرت إلى بيروت ومن هناك إلى قبرص ثم فيينا، حيث بدأت رحلة الاغتراب، وقبل سفري قدمت آخر لوحة لي هدية إلى المتحف الوطني، صالة الفن الحديث، وفي فيينا تعرفت على عالم مختلف تماماً، عالم حافل بصالات العرض والفنانين والمتاحف، لكن فيينا لم تكن أيضاً حميمة مع شاب يحمل اسماً عربياً وينام تحت جسورها أو في محطات قطاراتها وينتظر العشاء أمام إحدى دورها الخيرية للحصول على قطعة خبز محمصة أو شوربة ساخنة.
هكذا أمضيت السنوات الأولى وحيداً، أحمل لوحاتي من حين إلى آخر إلى صالات عرضها بلا اهتمام فعملت لصالح دكان لبيع اللوحات، وبدأت أخرج إلى الطبيعة، أرسم المشهد الانطباعي وتعلمت كيف يكون اللون وحركة الهواء، مع هذه الفصول الأربعة كانت بدايتي مع الخبز والشهرة وكان "مالفا" بديلاً عن"عمر حمدي" لضرورات التسويق، في عالم لم يتعلم بعد أن الإنسان واحد في كل مكان له تراثه وثقافته وخصوصيته.. ثم حصلت على الجنسية النمساوية وأصبحت عضواً في الاتحاد العام للفنانين النمساويين، ثم عضواً في لجنة التحكيم في تخرج الدبلوم لطلبة كلية الفنون.. وبدأت أعرض، ثم بدأت أعمالي تدخل أوروبا، بدءاً من ألمانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهكذا..
بعد رحلة الطبيعة كان عمر حمدي حاضراً كفنان، ذلك المغترب بحزنه وشوقه وخوفه وبراءته بعيداً قريباً من المكان، من الذاكرة السورية ورائحة التراب وحب الوالدة العجوز وهي تضع يديها على وجع قدميها، جالسة أمام الباب منتظرة وليدها الأول، لكن السنوات بزخمها وعذاباتها كانت طويلة الى أن تم اللقاء. ومن وقتها أعود من حين إلى آخر إلى الوطن، أعانق أهلي وأبحث عن أصدقائي القدامى أمتلئ بالانتماء ثم أسافر.
> ومرسمك ماذا يعني لك؟ وكيف هي علاقتك به؟ وكيف تنظر لبياض اللوحة؟
<<المرسم .. هو المكان الذي كنت أحلم فيه لسنوات طويلة، وهو اليوم على سفح جبل فيينا، بين غابة من الشجر، كبير يدخله الضوء بغزارة من جدرانه الزجاجية حين يكون الطقس شمساً، أدخله مثل ناسك، أسمع الموسيقى، أمتلئ بالشوق إلى اللوحة الفارغة، أتناول ألواني وفراشيّ وتبدأ المغامرة، مغامرة الكشف عن هذا المخزون النائم والمتراكم في الذات، عن التجربة الطويلة مع الحوار بين اليد والعين، عن ذلك السر اللانهائي بين الفنان ولحظة الإبداع، عن ملامح القلق الدائم مع اللون الطربي.. عالم من التداخلات المعقدة، لا تقبل الترجمة، أمنحها كل شيء لتعطيني كل شيء، مثل الجسد، مثل الطبيعة، مثل الوطن.
اللوحة مرآة اللحظة والساعات الطويلة من التأمل والأسئلة.. من أنا؟.. لماذا أرسم؟.. مع كل هذه المسؤولية تجاه الحياة والتطور الهائل للفنون الجديدة مع تقنيات ورؤى مستقبلية، تجعلني في النهاية أدافع عن نفسي على مساحة بلا حدود، عن اللوحة المحددة بأربع نهايات، عن موقعي وتأثيري ومكاني في هذا الزخم الهائل من الفنون، في يومنا هذا.. تعلمت بأن أكون منذ طفولتي وفي الغربة وبعد رحيل أطفالي الثلاثة إلى أمريكا وانقطاع أخبارهم عني لأكثر من خمسة وعشرين عاماً... لأنني وقتها لم أكن أكثر من رسام فقير، فقد حلمه بالعودة إلى الوطن الذي حمله معه، هذا الوطن الذي ظل يكبر في الذاكرة والعين، في لوحاتي وحياتي وثقافتي وعلاقاتي الإنسانية مع العالم الآخر.
في مرسمي أتأمل لوحاتي لأدخل لوحة جديدة، أي لعالم جديد من اللانهاية، ويأتي الليل، متعباً مثلي، أنام في مكاني، أستقبل الضوء وتبدأ الرحلة ثانية، أسافر، أدخل المدن الكبيرة، مازلت أهرب من الزحام، أدخل التفاصيل وأعيش متعة الروح في اللون والشكل، متعة الحياة بقدسيتها وجمالها، وأتعلم من جديد كيف أكون إنساناً.
وكيف بقيت محافظاً على ثقافة الشرق في أعمالك ضمن الثقافة الغربية؟
لم تكن مصادفة حين اختار التاريخ مكانه في سورية، ولم تكن مصادفة حين كتبت الأبجدية على قطع الطين المشوية ولم تكن الحضارة آنذاك تعرف بأن بقايا الحجر والتماثيل هي أحدث لغة في الفن المعاصر.. من هذه التربة ورائحتها خرجت إلى الغرب إلى العالم الكبير بحربيه العالميتين وتطوره التقني والمادي، بفنونه وحضاراته الإنسانية، مغترباً يحتمي بظل شجرة كبيرة يملأ عينيه من كل شيء، إضافات كبيرة تتراكم في الداخل تغنيني، أتأمل كل حدث جديد وأعود للجذور وتحولات التاريخ واستمرارية التراث والغرائز والحروب كشاهد على العصر، أصنع قدري بنفسي، أرسم لغتي، رؤيتي، أدافع عنها في كل مكان أعرض فيه، وأعرف أنني جدير بالمشاركة في الحوار من أجل سلام عادل على هذه الأرض ومن أجل كتابة تاريخ لم يكتب بعد، رسالتي هي الحب، هي عالم بلا حدود، عالم قابل للحياة، عالم يحترم الطبيعة، بأنها الأم المقدسة، عالم تملأ ساحاته بالألوان بدلاً من الدم، عالم نتحمل مسؤوليته من أجل البقاء والحرية والعدالة....
وهل يخضع عمر حمدي لمتطلبات السوق في فنه؟ أم أن إحساسه وما يشاهده هو المعيار لفنه؟
لم أرسم يوماً من أجل شيء سوى اللوحة، لأن اللوحة وحدها هي الخبز والبقاء والانتماء والتواصل، أعرف أننا في زمن يباع فيه كل شيء، وأعرف أن لوحتي تعلّق على جدار ما وليس في مرسمي، لكنني أرسم من أجل هذا الجدار سواء أكان في متحف أم في صالة عرض أم في ملتقى للفن أم في غرفة خاصة لإنسان ما..
في بدايات غربتي، حيث لا مال، لا أحد، لا اسم، كنت أرسم من أجل الخبز ومن أجل اللون، لكنني كنت سعيداً أنني قادر على الوقوف أنتظر العودة إلى عمر حمدي وإلى الحرية التي أستمدها من أعمالي بأنني واحد من فناني هذا العالم، جدير بالإضافة والتجديد.. ولأن المادة هي المحرك الأساسي في تاريخ الشعوب، والفن بحاجة إلى المتوفر المادي، فمن الرائع أن تُحدد أسعار أعمالي من صالات العرض وتُقتنى بهذه الغزارة، إنها سعادة الفنان حين تكون اللوحة جزءاً من سعادة الملتقى أو القادر على شرائها.. هكذا هي اللوحة لها قصتها أو سيرتها عبر التاريخ... وهي الحاضرة دائماً في الذاكرة الإنسانية كشاهد عصر وليس كشاهد نقدي.. اللوحة ليست رقماً أو ملكاً لأحد، إنها ملك نفسها فقط...
ترسم الوجوه بكل حالاتها الإنسانية، هل من علاقة تربطك بها؟
"الشاهد" أو الوجه الذي أرسمه، هو محاولة واقعية التفاصيل لأناس من دون إشارات أو دلالات محلية، هم "الإنسان" في وجهه، عذابه وحزنه، وتاريخه، تستوقفني هذه الوجوه التي تمر في حياتي وأحاول الدخول في تفاصيلها لأقول بصمت "أحبكم" هذه المجموعة هي جزء من أجساد جذوع الشجر أو من حقول اللون المتداخلة، لعوالم تجريدية حافلة بسيرة حياة ذاتية، ومعرفة محترفة مع الفن... لا يزال الوجه الإنساني بجغرافيته وحواره بديلاً عن وجهي، بديلاً عن لحظة حدوث الموت... أو القلق الدائم بين الحياة والموت.
والفن هل هو فعل تغيير؟ أم هو فعل مواز للحياة؟
الفن هو التاريخ، وهو الحضارة التي نعيشها اليوم ونرسم ملامحها للمستقبل، وبهذا فهو يغيّر ويدخل الحياة من حديقته الخاصة، لتكون الحياة أكثر جمالاً وتوازناً وتحملاً... هذا الفن بكل اتجاهاته من سينما ومسرح ولوحة ونحت وتقنيات ومواد معيشية وموسيقى وشعر، هو مجمل حياتنا بدءاً مما نرتديه إلى ما نودع فيه.. إنه الحافظ للتاريخ والديانات والقيم... ولد مع الإنسان وينتهي مع الطبيعة، فهو قدرنا وحياتنا واستمراريتنا... ما أرسمه في حدود اللوحة، هو المكان الذي لا يزال يرافقني، مكان أتعلم منه كيف أرسم وردة بيضاء بالدم...
والمرأة أين هي في أعمالك؟:
المرأة هي الحياة.. هي لوحتي، الجسد واللغة والاحتواء والوجه والذاكرة.. موجودة في جلد اللون وسطح المساحات، في التفاصيل، في روح المرئيات البصرية، علينا أن نرى ونتأمل طويلاً لنصل إلى التفاصيل وسر المكونات والمؤثرات غير المترجمة. إنها ربما سر الرسم في حياتي، هي مثل الطبيعة بفصولها، فهي سيدة الخلق والسلام وجديرة بالانتماء والتضحية.